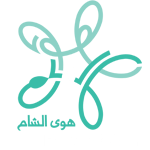خاص | هوى الشام
“الأمة التي لا تنتج واقعها لا تنتج ثقافتها…الصورة مضللة فبالظاهر تقدم وتجديد مجلوب من الخارج وفي العمق هو مشكلات الماضي يضاف لها مشكلات الحاضر” هو اقتباس بتصرف من حوار في مسلسل التغريبة الفلسطينية (2004).
طالما أن النكبة الفلسطينية (1948) جرح متجدد متمدد يمكننا النظر إلى حدث الماضي بعين الحاضر لنجد أن ما كان بالأمس شتاتا فلسطينيا هو اليوم شتاتاً عربياً بالجملة في كل بلاد الكوكب وبدايات متعثرة للاجئين طامحين بغد أفضل وجواز سفر ثان لأن سالم ابن أم سالم الثكلى قد وهبكم عمره.
نعم إنها العودة إلى دفاتر الماضي -إلى مسلسل التغريبة الفلسطينية – وتجرع كؤوس الأمجاد الآفلة على أبدع تحفة شُغلَت وتُشغَل وربما سوف تشغل عن فلسطين حملنا إليها “سالم” الوطن الذي تمناه الشاعر ابراهيم طوقان (نابلس 1905-1941) منعّما وغانماً مكرماً لكن الدكتور وليد سيف (مواليد طولكرم 1948) رآه خلافاً لذلك.
ذاك كان قلب الكاتب سيف, وليست كلماته, الحاضر على الورق مع شغف حاتم علي وحنكته في الإخراج وكتيبة من فناني الصف الأول من سوريا وفلسطين وأسطول من الفنيين ما خلق العمل بأحسن تقويم.

ورغم الحدث التراجيدي الجلل الذي يوثق النكبة ومن بعدها النكسة والكثير الكثير من المشاهد الدرامية وحتى الميلودرامية التي لا تخلو منها كل حلقة من الحلقات الواحدة والثلاثين، يسلك مسلسل التغريبة الفلسطينية منحى واقعيا بمزاج كئيب ولكن ليس تراجيديا على مستوى الشخوص إذ اتبع مسارات منطقية بعيدة عن المبالغة في معالجة مصائر هذه الشخصيات فيما يحط هذا الكُل التراجيدي رحاله بالتفاؤل والإصرار على الاستمرار في النضال مشكلا ملحمة حقيقية وتحفة بصرية وفكرية تشبع حواس المشاهد وعواطفه وتتركه أمام خبرة جديدة لن يكون من السهل عليه نسيانها.
تؤرخ التغريبة نحو ثلاثة عقود ضمن ثلاث مراحل، حيث ترصد الحلقات العشرة الأوائل المجتمع العربي في فلسطين والقيم السائدة في ثلاثينيات القرن الماضي خلال فترة الاحتلال الإنكليزي للبلاد وما تخلل تلك الفترة من فقر وقهر وتخلف اجتماعي وفكري إلى جانب تشكُّل الثورة العربية الفلسطينية ضد الإنكليز واستبسال مناضليها في مقاومة الاحتلال إلى أن قوضت بالهدنة، فيما كُرس الجزء الثاني لفترة التوطئة للاحتلال ووقوع النكبة وما تلاها من ويلات وشقاء الحياة في الخيام، أما الثلث الأخير فكان يمتد بُعيد وقوع النكسة ليرصد طبيعة الحياة في المجتمع الناشئ بالمخيمات ونمط المعيشة في أحياء تفتقر لأبسط سبل الحياة وما يحويه ذلك العالم من أمراض اجتماعية طبقية وعنصرية في جو من الرغبة بالارتقاء الثقافي والاجتماعي مع انعدام سبل الخلاص باستثناء التشريق إلى الصحراء أو التحصيل العلمي الذي كان المطية لأبناء المخيمات نحو الخارج والسبيل نحو غسل عار الفقر والصيت السيئ كما ظهر في مشاهد كثيرة ألقت الضوء على ممارسة الاضطهاد تجاه اللاجئين دونما الحاجة إلى توسع دائرة الأمثلة خارج نطاق البلد الواحد.

إذا على أرض هذا الوطن المنكوب بلغ التنافس الثقافي أشده بين أفراد الجيل الجديد من عائلة أبو أحمد (خالد تاجا) وسواها بالتالي باتت البيئة مثالية للاستعراض الفكري والطروحات الجدلية والإشكالية على متن الحوارات والرسائل في هذا المسلسل والتي – وإن كانت مبالغ بها بعض الشيء- إلا أنها أثرته وجعلت من الكثير من حواراته موضع اقتباس فيما تناولته من أراء سياسية ووجودية واستبطان نفسي حواري للشخصيات.
وكذلك لعب الحوار دورا هاما في دفع الأحداث إلى الأمام وكمثال على ذلك إقناع الجيل الجديد من العائلة والمتمثل بحسن (باسل خياط) و صالح الأشخاص الأكثر مرونة من الجيل القديم مثل أحمد (جمال سليمان) أو أكرم (مكسيم خليل) مقابل أبو أكرم (سليم صبري) حول ضرورة إعادة تقييم أحكامهم تجاه القضايا أو الأفراد بميزان أخلاقي لا يحمل ازدواجية معايير وكان لذلك الأسلوب العقلاني والسلس في الحوار دور في دفع الأحداث وإشراك المشاهد في الحكم من خلال مساعدته على تفكيك المفاهيم وإعادة صياغتها بعيدا عن الخطابية والمباشرة في الجانب الاجتماعي على الأقل.
منذ اللحظات الأولى للعمل يعي المشاهد مسَلّمتين اثنتين : الأولى موضوعية وهي وقوع النكبة والأخرى شاءها الكاتب لشخصيتي أحمد وعلي (تيم حسن) من خلال المشهد الافتتاحي حول نبأ وفاة الأول يتلقاه الثاني ونعلم أنه دكتور ليروي لنا بالخطف خلفا ما جرى. ورغم أننا سنتوقع الأحداث التاريخية وسنطمئن على مصير أحمد ومستقبل علي لكن التأسيس السليم لبيئة العمل والرسم المتقن للشخصيات المليئة بالتفاصيل إلى جانب الأحداث الدرامية التي تتوالى بسخاء منذ الحلقة الأولى وتدفع بعضها دون إقحام تدعنا بحالة ترقب وانتظار للمزيد، فبالإضافة إلى الذروة الأساسية (النكبة) ثمة العديد من الذرى الفرعية التي تتناوب على جميع الشخصيات الرئيسية من الجيلين الأول والثاني لعائلة أبو أحمد حيث تنشأ كل حبكة بحلقة وتبلغ ذروتها بالحلقة التالية ليكون الحل في الحلقة الثالثة تقريبا بترابط سلس فيما بينها يحافظ على التشويق ضمن الإطار التاريخي العام ويغذي الحبكة الأساسية ويجعلنا نقيم علاقة متينة مع الشخصيات التي تشهد تطورا مع مضي العمل.
ولعل أكثر هذه الشخصيات تعقيدا وتناقضا هي شخصية مسعود (رامي حنا) البراغماتية الذكية والديناميكية وبنفس الوقت ذات نزعة وجدانية وغيرية في حين رسمت شخصية حسن (باسل خياط) لتقدم كقربان منذ البدايات وحسبه أنه حوّل نفسه من ضحية الظلم الاجتماعي لأضحية دفاعاً عن أرضه. ولم تغب الشخصيات الرمزية عن العمل مثل جميلة (نسرين طافش) والتي تمثل فلسطين الجميلة وشخصية سعيد (أدهم مرشد) الذي نضح بالتفاؤل والحب والإقبال على الحياة، فهو يجسد الحلم الضائع فيما يمثل سالم (الوسادة) الجسد العربي الأشبه بالجثة الهامدة.
ويحمل المسلسل مقولات متعددة ذُكرت آنفاً لكن لعل أبرزها أتى على لسان حسن في مشهد وداعه لقبر جميلة قائلا بتصرف “قتلوك ولاد العرب واخذوا أرضك اليهود” في إشارة إلى الهدنة التي أنهت الثورة الفلسطينية وأوكلت أمر فلسطين إلى الجيوش العربية، ولم تكن أحداث النكسة في حزيران 1967 فيما تلا خلافاً لذلك مع تكرار مصطلح “ماكو سلاح” الرديف لها.

واعتمد حاتم علي على اللقطات المتحركة (بانات من الخارج إلى الداخل) في بدايات المشاهد لتؤسس للمكان ثم تأخذنا من يدنا لندخل معها إلى عوالم كل مشهد وخلق تورط المشاهد مع الحدث الدرامي وبذلك أيضا يبعد الملل ويتجنب الأسلوب التوثيقي باستثناء بعض المواد الأرشيفية التي تعود إلى زمن النكسة ما دفع بالعمل خطوة نحو العالم الحقيقي فيما عكست الكوادر الثابتة العامة جماليات المشاهد فاستطاعت من خلالها أن تخلق تعاطفاً مع قضية اغتصاب الأرض وشعورا بالحسرة عليها دون الحاجة للاستجداء اللغوي.

أما كوادر أخرى فقد لعبت دوراً سردياً هاماً في نقل مضامين معينة تتمم المعنى كالتوكيد على القيم التضحوية التي يتمتع بها حسن عندما ظهر غصن الزيتون مع نهاية حوار ملهم دار بينه وبين أخيه علي حول تحصيل الحقوق بالنضال.
وكادر آخر يظهر به أبو عايد (حسن عويتي) جنباً إلى جانب أم سالم بما يفيد التساوي بينهما في الاعتلال العقلي.

ويشي بعض تلك الكوادر بما هو آت مثل ظهور المقابر كخلفية لعايد في رحلته مع سعيد ومسعود في الصحراء منذر بموت قريب، أما الكادر الأبلغ والذي يحمل مقولة أخرى يختتم به العمل هو لقطة عامة لرشدي (حاتم علي) وهو يزيح الصخرة ويدخل المغارة حيث خبأ بندقية والده الشهيد العبد (خالد القيش) ليكمل النضال فيفيض النور في كناية صريحة تحاكي قيامة المسيح في سبت النور بحسب المعتقد الأرثذوكسي.

موسيقا التغريبة لعبت دور النسيج الضام للخلايا إذ احتضنت كافة المشاهد وجعلتها كلاً واحداً بنكهة الزعتر والبرتقال الفلسطيني ابتداء من شارة البداية في قصيدة للشاعرابراهيم طوقان إلى الأغاني الشعبية المحلية واللوازم ذات الإيقاع العسكري التي ترافق المشاهد الحربية وتهليلات النصر وأناشيد الرثاء إضافة إلى الأغاني التي كانت توثق المراحل الزمنية ابتداءا بمحمد عبد الوهاب وصولا إلى فيروز.
فيلم كل عام على الأقل تنتجه هوليوود والسينما الأوروبية عن الهولوكوست التي وقعت بين عامي 1941 و1945 أي بعد إعطاء الاحتلال الانكليزي وعد بلفور (1917) سيئ الصيت لليهود بإقامة وطن لهم على أرض فلسطين وفي الوقت الذي استصرخ فيه اليهود العالم وحشية النازية أتت الصهيونية بمثلها، أما نحن كمتلقين فما علينا سوى أن نذرف دموع التعاطف مع ميلودراما ضحايا النازية على ألا ننسى توفير الكثير منها على من ذبحوا في الجانب الآخر دون أية عروض شبيهة بتراجيديا أطفال الصناديق. فهل رفعت الأقلام وجفت الصحف من بعد هذا العمل التليد، أم أن النكبات الارتدادية اللا متناهية في هذه البلاد خطفت بريق النكبة الأم؟
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))